دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لجميع البشر منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة.. فما بعض محاسن هذا الدين العظيم؟
ملخص المقال
المتجول في شوارع قرطبة جوهرة العالم سيتنسم عبق الحضارة الإسلامية الزاهرة، فما الذي جعل قرطبة تتبوأ هذه المكانة؟
 كما أوضحت آنفًا، فليس الهدف من هذه السلسلة (ثقة في الماضي.. يقين في المستقبل) بإذن الله هم استعراض القدرات الخطابية، وإرضاء نزعات الجعجعة المتغلغلة في كياننا، وإنما محاولة لرأب الصدع -المتمثل في حاضرنا القاتم- بين ماضي أمتنا الزاهي ومستقبلها الزاهي بإذن الله، أي -ببساطة- أن نستمد من طاقة إبداع ماضينا ما يدفعنا إلى الأمام، وما يمنحنا الثقة والرسوخ.
كما أوضحت آنفًا، فليس الهدف من هذه السلسلة (ثقة في الماضي.. يقين في المستقبل) بإذن الله هم استعراض القدرات الخطابية، وإرضاء نزعات الجعجعة المتغلغلة في كياننا، وإنما محاولة لرأب الصدع -المتمثل في حاضرنا القاتم- بين ماضي أمتنا الزاهي ومستقبلها الزاهي بإذن الله، أي -ببساطة- أن نستمد من طاقة إبداع ماضينا ما يدفعنا إلى الأمام، وما يمنحنا الثقة والرسوخ.
وقد آثرت ألا أسير وفق الترتيب التاريخي للأحداث؛ وذلك لأمنح نفسي حرية التجوال في رحاب ماضينا الفسيحة، وكذلك لعجز شخصي الضعيف عن الإلمام بكافة مراحل ومنعطفات تاريخنا الحافل، فقنعتُ نفسي بعدة قطرات جلبتها من هنا وهناك، من خضمه الزاخر!! وقررت أن أشارككم جميعًا الارتواء بها.
ولننتقل إلى القطرة الأولى!
نحن الآن على أعتاب قرن جديد، هو القرن الرابع من هجرة الرسول r، أي أنه قد مر على البشرية ثلاثمائة عام منذ الحدث التاريخي العظيم، الذي قلب موازين الحياة الإنسانية، وهو بالطبع الهجرة النبوية العظيمة، التي لم تكن انتقالاً مكانيًّا بين مكة ويثرب (المدينة المنورة فيما بعد)، وإنما كانت انتقالاً جذريًّا لدين الإسلام وأمته من مرحلة الاضطهاد والصبر في مكة، إلى مرحلة الدولة والتمكين في مدينة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في بادئ الأمر، ثم جزيرة العرب كاملة إبان وفاته r، ثم انبثقت أنوار الرسالة المحمدية في كافة الاتجاهات، فلا يمر قرن من الزمان إلا وقد طوى الإسلام ما بين الصين شرقًا والأندلس غربًا، وكان المسلمون بلا منازع أسياد الدنيا ودولتهم الشامخة، تقطر عربات الحضارة الإنسانية التي تعطلت منذ قرون.
لكن في أوائل القرن الرابع الهجري، لم تكن الحال بهذا الجمال؛ فقد انقسمت بلاد المسلمين دولاً وأحيانًا دويلات، وتنازع المسلمون الدنيا، وانفرد كل أمير بمنطقته، وأصبح الخليفة العباسي في بغداد اسمًا بلا رسم، وقوة سلطانه لا تتعدى حدود قصره المنيف في بغداد! هذا إذا لم يقتحمه بعض الأمراء الطامعين، ليجبر الخليفة على منحه ولاية أو سلطنة!! وطمع الأعداء في ثغور المسلمين، وتقطعت أوصال ديار الإسلام، ووصل الحال إلى أن القرامطة -وهم قوم فاسدو العقيدة، استقلوا بدولة لهم عن الخلافة- عاثوا فسادًا في العراق وجزيرة العرب، وبلغ سيلهم الزُّبَى عندما اقتحموا مكة المكرمة، وقتلوا الآلاف من حجيجها! ولم يقوَ على ردهم عن هذا الفساد أحد.
ورغم أن الحضارة العمرانية والعلمية والمعرفية في حواضر الإسلام الكبرى -كبغداد ودمشق وسمرقند و... إلخ- ظلت محتفظة ببعض البريق، وظلت أرقى من سواها من مناطق الدنيا، إلا أن استمرار التفسخ السياسي والعسكري كان ينذر بزواله؛ إذ لا يصح أن تكون أمة الإسلام مشرذمة متهتكة، بأس أبنائها بينهم شديد، تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى! ليس لأمتنا تمكين في مثل هذه الأوضاع.
وحدها... وحدها كانت تشرق حقًّا بجلال الإسلام، ولكنه إشراق عجيب، فقد اعتدنا أن تشرق الشمس من المشرق في كل يوم، لكنها شمس مغاربية، أشرقت من الغرب إلى الشرق، بل إلى كل اتجاه... إنها شمس الأندلس.
نحن الآن في قرطبة -عاصمة الأندلس- وتلوح في الأفق مئذنة جامعها السامقة، هذا الجامع الجامعة الذي يؤمه في كل يوم الآلاف من طلبة العلم، من كافة أقطار البلاد الإسلامية بل غير الإسلامية، ليعبوا من مختلف العلوم والمعارف الإنسانية، فهنا الفقه الإسلامي والحديث والفلك والفلسفة والطب والحيل (الميكانيكا) والتاريخ والرياضيات والكيمياء و... و... إلخ.
وتبدو على مرمى البصر أنوار مدينة الزهراء العظيمة، التي تضم في جنباتها دواوين الحكم التي تسيِّر مصالحَ الأندلس ومصائرَها الكبرى، كما حوت مكتبتها العظيمة التي تحوي كنوز العلوم المجموعة من كل حدب وصوب، كما ضمت أيضًا قصور حاكم الأندلس الفذ عبد الرحمن الناصر الأموي -رحمه الله-، الذي تربع على عرش الأندلس والمغرب نصف قرن، فكان حكمه رخاءً سخاءً، ووحدةً وانتماءً. وتواردت عليه فيها رسل وسفارات معظم ممالك أوربا... الأبعدون يطلبون صداقة أقوى رجل على وجه الأرض، والذي يحكم أزهى دولها... والأقربون يقبلون الأرض بين قدميه، يرجون استمرار عهود السلم والموادعة.
والمتجول في شوارع قرطبة (جوهرة العالم، كما كانت تلقب آنذاك)، سيتنسم -بلا شك- عبق الحضارة الإسلامية الزاهرة، بمساجدها العامرة، جميلة المبنى والمعنى، فهي عامرة بعظمة بنيانها وروعة الزخارف على جدرانها، وعامرة بآلاف المصلين وطلبة العلم الذين يمثلون العمران الحقيقي لبيوت الله.
ولا يخلو المشهد كذلك من الكنائس والمعابد التي تعبر عن سماحة الإسلام ورحابة صدر أمته التي فتحت ذراعيها للآخر المختلف عنها في الدين، فهي أمة الحب والعدل.. أمة لا إكراه في الدين.
ولا بد أن تنذهل عيناك من روعة قصورها ونظافة شوارعها وحسن تخطيطها، ولا بد أن تأسرك روعة بساتينها، وأن يخلب لبّك مرأى أنهارها. وهكذا كانت تقدم الأندلس الحل الفريد لمعادلة الدنيا والآخرة؛ فالمسلم الأندلسي كان يحيا في فردوس الله على الأرض، وله -إن أخلص العمل لله- فردوس الآخرة خير مستقرًّا وأحسن قيلاً.
وعلى البعد من قرطبة في اتجاه الشمال، كانت الثغور، وهي المدن والحصون المقابلة لأرض العدو النصراني المتربص في شمال الجزيرة منذ قرون، والذي يترقب الفرص السوانح للانقضاض على خيرات الأندلس، ولكن هيهات! فجيش الثغور الأندلسي يرابط في المدن والحصون في أتم العدد والعدة، وعيونه تعد على العدو أنفاسه، وما إن تلوح بادرة للغدر ونقض عهود السلم والموادعة، حتى يصيح داعي الجهاد، وتنفر جنود الإسلام، وتندفع إلى عمق مدن العدو وقراه، لتعيد إليه رشده، فيطلب الصفح والعفو والصلح، ويؤجل تحقيق أطماعه إلى يوم سيأتي عاجلاً أو آجلاً، تكون فيه قلوب المسلمين متفرقة، وأهواؤهم شتى، وراية الجهاد منكسرة... حينها -وحينها فقط- تكون الفرصة فعلاً سانحة، لازدراد لقمة الأندلس السائغة.
وعلى هذه الحال مضى القرن الرابع الهجري، فكان حقًّا قرن الأندلس، وبينما كانت أوربا في عصورها المظلمة تتقلب في غياهب التخلف المزري منذ قرون، كانت الأندلس في عصرها الذهبي وحدةً واحدة، تحميها جيوش الجهاد الظافرة، وتنهض بها إلى الأعالي روح إسلامية فجرت في أرجائها ينابيع العلوم والمعارف والعمران والرقي والحضارة والأخلاق الرفيعة، وتثبت أركان دولتها أسس العدالة.
وبالطبع لم يخلُ المشهد من بعض المظالم والأخطاء، فالإسراف -مثلاً- والمبالغة في الترف نذيرا شؤم، والبذخ الشديد والحياة المرفهة لدى الكثيرين لا بد أن ينعكسا سلبًا على روح الأمة ووجدانها، لكن الحضارة هي في النهاية منتج بشري، ولا يخلو ما نسب إلى البشر من عنصر الخطأ، وإلا فما بشريته؟!!
وبالفعل أتت عصور على الأندلس بعد ذلك، نسي فيها أهلها أسباب عزتهم الحقيقية، وانصرف أكثرهم إلى الملذات والشهوات، وانقسمت أرضها دويلات وطوائف، وتنازع حكامها فتات السلطان، فعاجلهم الله بالخسران، وانقض عدوهم على الأندلس يلتهمها قطعة قطعة، ويطمس معالم وجهها الإسلامي، وصاح شاعر الأندلس يبكي ماضيها التالد ويبكينا قائلاً:
لكل شيء إذا ما تم نقصـانُ *** فلا يُغَرَّ بطيب العيش إنسـانُ
هي الأمور كما شاهدتها دولٌ *** مـن سَرَّهُ زمنٌ ساءتهُ أزمـانُ
والآن فلنعد من حيث ذهبنا، ولنحط رحالنا في الواقع المعاصر من جديد، وعسانا نكون أفدْنَا من درس من دروس الأندلس التي لا تنقضي، وعسى الله أن يوفقنا لنكون صلة الماضي بالمستقبل.
ولكن أمامنا درب طويل، بالعزم يقصر.. إنه درب العلم والعمل يحفه سياج الإخلاص والإيمان بالمعز المذل I، مالك الملك الذي يعطى الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.








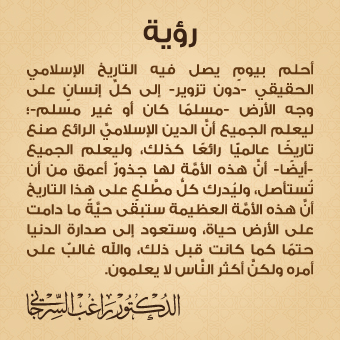


التعليقات
إرسال تعليقك