المتأمل في تاريخ الأندلس يتعجب من تعصب الأندلسيين للمذهب المالكي، فما سر انتشار المذهب المالكي في الأندلس؟ وهل كان التعصب للمذهب المالكي سببا في سقوط الأندلس؟
ملخص المقال
يحكي المقال قصة سقوط قرطبة عاصمة الأندلس بيد النصارى القشتاليين بعد أن تآمر عليها العدو والصديق، فكيف سقطت قرطبة؟
دولة ابن هود
على أنقاض دولة الموحدين التي انفكت عراها بعد هزيمتهم المدوية في معركة العقاب في (15 من صفر 609هـ=16 من يوليو 1212م) المعروفة أمام الجيوش الإسبانية والأوربية المتحالفة، نجح محمد بن يوسف بن هود في أن يُقيم دولةً كبيرةً ضمَّت قواعد الأندلس الكبرى، مثل: إشبيلية حاضرة الحكم الموحدي، وشاطبة، وجيان، وغرناطة، ومالقة، وألمرية، وأصبح بعد هذا النجاح زعيم الأندلس وقائد حركة تحريرها والدفاع عنها أمام أطماع النصارى التي ليس لها حد؛ ولذلك دخل في معارك معهم أصابه التوفيق في بعضها، وحلَّت به الهزيمة في بعضها الآخر.
ومحمد بن يوسف بن هود كان قبل أن يظهر أمره من أجناد "مرسية" ومن بيتٍ عريقٍ في الزعامة والرياسة؛ فهو سليل بني هود ملوك سرقسطة أيام حكم الطوائف، استطاع أن يجمع حوله الأتباع والأنصار، وأن يُحارب بهم دولة الموحدين، وكانت تمرُّ بظروفٍ حرجةٍ فلم تقوَ على الوقوف أمامه، فتساقطت مدنها في يده بعدما اشتدَّ أمره وذاع ذكره.
التبعية للدولة العباسية
رأى ابن هود منذ أن استفحل أمره أن ينطوي تحت الخلافة العباسية في بغداد، ويستظل بظلها، وأن يتَّشح بثوبٍ من الشرعيَّة في انتحال الولاية، ويستقوي بها في محاربة خصومه؛ فرفع الشعار الأسود شعار العباسيين، ودعا للخليفة المستنصر بالله العباسي، وبعث إليه في بغداد يطلب منه مرسومًا بولايته على الأندلس، فبعث به إليه ومعه الخلع والرايات، واستقبل ابن هود مبعوث الخليفة سنة (630هـ=1233م) وكان يومئذٍ بغرناطة.
فقُرئ المرسوم على الناس، وجاء فيه أنَّ الخليفة قلَّده "أمر جزيرة الأندلس وما يجري معها من الولايات والبلاد، ويسوغه ما يفتتحه من ممالك أهل الشرك والعناد تقليدًا صحيحًا شرعيًّا"، ثم يُقدِّم له الخليفة بعض النصائح تتضمَّن التمسُّك بتقوى الله، والتزام كتابه وسنَّة نبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يُكثر من مجالسة الفقهاء والعلماء، ومشاورة العقلاء الألباب، وأن يُحسن السيرة في الرعيَّة وأن يُعنى بمجاهدة الكفار.
وبهذا المرسوم صار ابن هود أمير الأندلس الشرعي، وكان ملكه يومئذٍ يمتدُّ في شرق الأندلس من الجزيرة وشاطبة حتى ألمرية جنوبًا، وفي وسط الأندلس فيما بين قرطبة وغرناطة، ولم يخرج عن سلطانه سوى عددٍ قليلٍ من قواعد الأندلس الكبرى.
صراع ومنافسة
ولم يكن ابن هود منفردًا بحكم الأندلس، ولم تتَّحد قواعدها الكبرى تحت سلطانه؛ فقد نافسه في شرق الأندلس "أبو جميل زيان بن مردنيش" وكانت بلنسية تحت يده، وفي وسط الأندلس وجنوبها نافسه "محمد بن يوسف الأحمر" وكان زعيمًا شجاعًا مقدامًا، أهَّلته مَلَكَاته ومواهبه أن يشتدَّ أمره ويضع يده على "جيان" وما حولها، وأن يتطلَّع إلى أن يبسط سلطانه على قواعد الأندلس في الجنوب.
واستشعر ابن هود بقوَّة منافسه ابن الأحمر وتوجَّس منه خيفةً ومن تطلُّعاته الطموحة، فشاء أن يقضي على آمال خصمه قبل أن تتحول إلى حقيقة ويعجز هو عن إيقاف مدِّه والقضاء على خطره، فلجأ إلى السيف لتحقيق ما يتمنى، ولم يكن خصمه القوي في غفلةٍ عما يُدبَّر له، فاستعدَّ ليوم اللقاء، وعقد حلفًا مع "أبي مروان أحمد الباجي" القائم على إشبيلية التي خرجت من سلطان ابن هود.
وكان ممَّا لا بُدَّ منه، والتقى الفريقان على مقربةٍ من إشبيلية في معركةٍ حاميةٍ في سنة (631هـ=1233م)، وانتصر الحليفان على غريمهما ابن هود، ودخل ابن الأحمر إشبيلية بعد ذلك، وهو يضمر في نفسه التخلُّص من حليفه الباجي، فدسَّ له من يقتله، وحاول أن يبسط يده على إشبيلية فلم يتمكن، وثار عليه أهلها، وأخرجوه منها بعدما علموا بفعلته مع زعيمهم أبي مروان الباجي، وأرسلوا إلى ابن هود يُسلِّمون له مدينتهم لتكون تحت حكمه وسلطانه.
الرجوع إلى الحق
وحدث ما لم يكن متوقعًا؛ فقد حلَّ السلم والصلح بين الزعيمين المتخاصمين، ولعلَّهما أدركا خطر الحرب بينهما واستنزاف الأموال والدماء في معارك لن يستفيد منها سوى عدوهما المشترك ملك قشتالة، فغلَّبا صوت العقل وخلق الأخوة على التنافس البغيض، وعقدا الصلح في (شوال 631هـ=يونيو 1234م)، واتفقا على أن يقرَّ ابن الأحمر بطاعة ابن هود على أن يقره الأخير على ولايتي أرجونة وجيان.
وفي هذه الفترة لم يكن فرناندو الثالث يكف عن شنِّ غزواته وحروبه، ولا يهدأ في إرسال جيوشه تعبث في الأرض فسادًا، وكان ابن هود يردُّه في كلِّ مرَّةٍ بعقد اتفاقيَّةٍ وهدنة، ويدفع له إتاوةً عالية، وينزل له عن بعض الحصون، وكان فرناندو يهدف من وراء غزواته المتتالية أن يُرهق المسلمين ويستولي على حصونهم، حتى تأتي الفرصة المواتية فينقض على قرطبة تلك الحاضرة العظيمة ذات المجد الأثيل ويستولي عليها.
ولم تكن المدينة العظيمة في أحسن حالتها، تضطرب الأمور فيها اضطرابًا، تميل مرَّةً إلى ابن الأحمر، ومرَّةً أخرى إلى ابن هود، لا تتَّفق على رأي، ولا تُسلِّم زمامها لمن يستحق وتمكنه قدرته وكفاءته من النهوض بها، وتفتك الخصومات والأحقاد بها، ويبدو أنَّ الملك القشتالي كان على علمٍ بعورات المدينة، ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض عليها.
غزو قرطبة
وأواخر (ربيع الآخر 633هـ=1236م) خرج جماعةٌ من فرسان قشتالة المغامرين صوب قرطبة، واحتموا بظلام الليل وخيانة البعض ونجحوا في الاستيلاء على منطقة من مناطق المدينة تُعرف بالربض الشرقي، وكانت قليلة السكان، ضعيفة الحراسة، وقتلوا كثيرًا من سكانها، وفرَّ الباقون إلى داخل المدينة، وبعدما زالت المفاجأة جاءت حامية المدينة وهاجموا هؤلاء الغزاة الذين تحصنوا بالأبراج، وبعثوا في طلب النجدة والإمداد، فجاءتهم نجدةٌ صغيرةٌ من إخوانهم النصارى، وتحرَّك فرناندو على الفور صوب قرطبة، غير ملتزمٍ بالمعاهدة التي عقدها مع ابن هود الذي تتبعه المدينة، وبدأت تتجمَّع قوَّات من النصارى تحت أسوار المدينة ويزداد عددها يومًا بعد يوم، وتتوقَّد قلوبهم حماسةً وحميَّة، وبدأ الملك يضع خطته للاستيلاء على المدينة العظيمة.
موقف ابن هود
تطلع القرطبيون في هذه اللحظات الحرجة إلى ابن هود لإنجادهم والدفاع عن مدينتهم باعتباره حاكم المدينة الشرعي، فاستجاب لهم حين علم بالخطر الداهم الذي يُحيط بالمدينة العريقة، وخرج في جيشٍ كبيرٍ من بلنسية إلى قرطبة، وعسكر على مقربة منهم، وكان أهل قرطبة ينتظرون مقدمه واشتباكه مع النصارى في موقعة فاصلة، وبدلًا من أن يفعل ذلك ظلَّ واقفًا في مكانه لا يُحرِّك ساكنًا، ولا يتحرَّش بهم، ولو أنَّه اشتبك معهم لحقَّق نصرًا كبيرًا وألحق بهم هزيمةً كبيرة، فحشودهم لم تكن ذات شأن، جمعتها الحماسة والحميَّة، وفرسانهم لم يكن يتجاوزوا المائتين.
ويختلف المؤرِّخون في السبب الذي جعل ابن هود يقف هذا الموقف المخزي، وهو الذي ملأ الأندلس كلامًا بأنَّه سيعمل على تحرير الأندلس من عدوان النصارى، وعلى إحياء الشريعة وسننها؛ يذهب بعض المؤرِّخين إلى أنَّ قسوة الجوِّ وهطول الأمطار بشدَّة ونقصان المؤن هو الذي حمل ابن هود على اتِّخاذ هذا الموقف.
وتذهب بعض الروايات أنَّ أحد رجال ابن هود وكان مسيحيًّا قشتاليًّا خدعه وأوهمه بأنَّ الملك في أعدادٍ كبيرةٍ من جيشه، مجهَّزة بأقوى الأسلحة وأفتكها، وأنَّه لا يأمل أن يتحقَّق النصر على جيشٍ مثل هذا، فانخدع له ابن هود وتخلَّى عن نجدة أهل قرطبة.
وأيًّا كانت الأسباب التي يلتمَّسها المؤرِّخون لموقف ابن هود فإنَّ ذلك لن يُغيِّر من الحقيقة شيئًا، وهو أنَّ ابن هود ترك قرطبة دون أن ينجدها ويضرب القوَّات التي تُحاصرها، ولم يكن عاجزًا أو ضعيفًا؛ فقوَّاته كانت تتجاوز خمسة وثلاثين ألف جندي، لكنَّه لم يفعل.
سقوط قرطبة
لم يعد أمام قرطبة بعد أن تركها ابن هود تلقى مصيرها سوى الصمود ومدافعة الحصار الذي ضربه حولها فرناندو الثالث، الذي قطع عنها كلَّ اتصالٍ عن طريق البرِّ أو عن طريق نهر الوادي الكبير؛ فانقطعت عنها المؤن والإمدادات وكل ما يجعلها تقوى على الصمود، وظلَّ هذا الوضع قائمًا حتى نفدت موارد المدينة المنكوبة ونضبت خزائنها، واضطر زعماء المدينة إلى طلب التسليم على أن يخرجوا آمنين بأموالهم وأنفسهم، فوافق الملك على هذا الشرط.
وفي أثناء المفاوضات علم أهل قرطبة أنَّ الجيش القشتالي يُعاني من نقص المؤن مثلما يُعانون، فابتسم الأمل في نفوسهم، فتراجعوا عن طلب تسليم المدينة أملًا في أن يدفع نقص المؤن الجيش القشتالي على الرحيل ورفع الحصار، لكن أملهم قد تبدَّد بعد أن تحالف ملك قشتالة مع ابن الأحمر أمير جيان، فتآمر عليهم العدو والصديق، ولم يجدوا بدًّا من التسليم ثانيةً بعد أن تعاونت الخيانة مع ضياع المروءة والشرف في هذا المصير المحتوم.
وأغرى هذا الموقف المخزي بعض القساوسة الغلاة في أن يُصرَّ الملك على فتح المدينة بالسيف وقتل من فيها، لكنَّ الملك رفض هذا الرأي خشية أن يدفع اليأس بأهل قرطبة إلى الصبر والصمود وتخريب المدينة العامرة وكانت درَّة قواعد الأندلس، فآثر الموافقة على التسليم.
وفي يومٍ حزينٍ وافق (الثالث والعشرين من شهر شوال 633هـ=29 من يونيو 1236م) دخل القشتاليون المدينة التليدة، ورُفع الصليب على قمَّة صومعة جامعها الأعظم، وصَمَتَ الأذان الذي كان يتردَّد في سماء المدينة أكثر من خمسة قرون، وحُوِّل المسجد في الحال إلى كنيسة، وفي اليوم التالي دخل فرناندو قرطبة في كوكبةٍ من جنوده وأتباعه، وهو لا يُصدِّّق أنَّ ما يحلم به قد تحقَّق، لا بقدرته وكفاءته وإنَّما بتنازع المسلمين وتفرُّقهم، ووطئت أقدامه عاصمة الخلافة في الأندلس لا بشجاعة جنوده وبسالتهم وإنَّما بجبن قادة المسلمين وحكامهم.
وهكذا سقطت المدينة التليدة التي كانت يومًا ما مركز الحكم، ومثوى العلوم والأدب، ومفخرة المسلمين.
_______________________
من مصادر الدراسة:
- ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تطوان – المغرب، 1960-1964م.
- ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني - بيروت، 1981م.
- محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس، عصر المرابطين والموحدين، مكتبة الخانجي – القاهرة، 1411هـ=1990م.
- عبد الرحمن علي حجي: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، دار الاعتصام - القاهرة، 1403هـ=1983م.








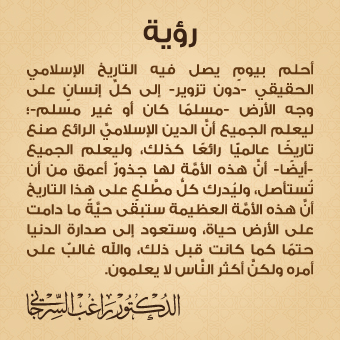


التعليقات
إرسال تعليقك