قبة النسر في الجامع الأموي، والتي تعد من أشهر القباب في العمارة الإسلامية، ورائعة من روائع الحضارة الإسلامية، فماذا عن تاريخها ووصفها ومعالمها ؟
ملخص المقال
للقاهرة الفاطمية القديمة عدت أباب وأسوار تم تشييدها لأسباب مختلفة، فما هي أسباب تشييد أبواب وأسوار القاهرة القديمة؟ وما السر وراءها؟
جوهر الصقلي وبناء القاهرة
بعد دَحْره الإخشيديين دخل جوهر الصقلي مدينةَ الفسطاط مساء 17 شعبان عام 358هـ (6 يوليو 969م)، ثم غادرها شمالاً إلى موقع كان يعرف بالمناخ، حيث كانت تستريح القبائل بإبلها، وهو عبارة عن سَهْل رمْلِي، يَحُدُّه مِن الشرق جبلُ المُقطَّم، ومِن الغرب خليج أمير المؤمنين (فرعٌ مِن النِّيل كان يتصل بالبحر الأحمر)، وكان يمتَدُّ ليصل بين شمالي الفسطاط ومدينة هليوبوليس القديمة، وينتهي عند القِرْم (السويس) على البحر الأحمر... وكان هذا السهل خاليًا من البناء، إلا مِن بضعة مَبانٍ ملحَقةٍ ببساتينِ وأشجارِ الكافور، ودِيرٍ فَسِيح للنصارى اسمه دير العظام، وحصنٍ صغير يسمَّى "قصر الشوك".
وبدخول جوهر الصقلي بدأ عهد جديد لمصر في ظل الحكم العبيدي (الفاطمي)، ووضع جوهر الأساس لبناء مدينة المنصورية في 17 شعبان سنة 358هـ شمالي الفسطاط وأسس القصر الذي سينزل به المعز وعرف باسم القصر الشرقي الكبير.
ظلت القاهرة تعرف بالمنصورية أربع سنوات، ثم سماها المعز القاهرة تفاؤلا بأنها ستقهر الدولة العباسية، وجعل جوهر بسور القاهرة أربعة أبواب؛ باب النصر، باب الفتوح، باب زويلة، وباب القوس. وجاء سور القاهرة من الطوب اللبن على شكل مربَّع، طولُ كلِّ ضِلع مِن أضلاعه 1200 ياردة، وكانت مساحةُ الأرض التي ضمَّها السور المربَّعُ 340 فدانًا، منها نحو سبعين فدانًا بَنَى عليها جوهرٌ القصرَ الكبير، وخمسة وثلاثين للبستان الكافوري، ومِثلُهما للميادين، والباقي جرى توزيعه على الفرق العسكرية لتشييد حاراتها.
وكان غرض جوهر من إنشاء القاهرة أن تكون معقلاً حصينًا؛ لِرَدِّ قرامطة البحرين عن الفسطاط ليقاتلهم مِن دونها؛ ولذا أحاط بها بسور من الطوب اللَّبِن، وجعل بداخل هذا السور معسكراتِ قواته، وقصرَ الخليفة، والمسجد الجامع (الأَزهر)، الذي بدأ بناؤه سنة 359هـ وتم بناؤه في سنتين، وذلك ليكون خاصا بشعائر المذهب العبيدي الفاطمي، خشية إثارة المصريين إذا ظهرت هذه الشعائر في مساجدهم.
وقد تم حفر خندقًا عميقًا من الجهة الشمالية؛ ليمنع اقتحام جيش القرامطة للحصن، ولمصر مِن ورائه، وكانت المياهُ تَجري إليه مِن خليج أمير المؤمنين؛ ليصبح عائقًا مزدوجًا على المهاجمين، تجاوزه قبل الوصول إلى أسوار المدينة، التي كانت سميكة إلى حد أن تستوعب مرور فارسين بخيولهما وهما يسيران جنبا إلى جنب [1].
سبب تسميتها القاهرة
وقيل في سبب تسميتها القاهرة: أن جوهرًا الصقلي لما أراد بناءها أحضر المنجِّمين، وعرَّفهم أنه يريد عمارة بلدٍ ظاهر مصر (خارج الفسطاط) ليقيم بها الجند،، وأمرهم باختيار طالع لوضع الأساس، فاختاروا طالعا لحفر السور، وطالعا لابتداء وضع الحجارة في الأساس، وجعلوا بدائر السور قوائم من خشب، بين كل قائمتين حبل فيه أجراس، وقالوا للعمال: "إذا تحركت الأجراس ارموا ما بأيديكم من الطين والحجارة".
فوقفوا ينتظرون الوقت الصالح لذلك، فاتفق أن غرابا وقع على حبل من تلك الحبال المعلق فيها الأجراس، فتحركت الأجراس كلها، وظن العمال أن المنجمين حركوها، فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة وبنوا، فصاح المنجمون: "القاهر في الطالع". يَعنُون بذلك كوكبَ المرِّيخ، فتم البناء على غير الطالع الذي أراده جوهر الصقلي [2].
أبواب القاهرة
تُعَدُّ الأبواب التي ظهرت في أسوار القاهرة خلالَ العصور الثلاثة التي نشأت فيها من روائع العمارة الحربية في الحضارة الإسلامية؛ لِمَا تميَّز به مِن شموخ وروعة وجمال في الفن المعماري والتصميم، ففي الأسوار التي أقامها جوهر الصقلي وجددها بدر الجمالي، اشتهرت بمجموعة مِن الأبواب التي تمثِّل العمارة الحربية في العصر الفاطمي، وتعبِّر عن الهيبة والعظمة لذلك العصر.
وكان للقاهرة من جهتها القبلية: بابان متلاصقان يقال لهما: باب زويلة، ومن جهتها البحرية: بابان متباعدان، أحدهما: باب الفتوح، والآخر: باب النصر، ومن جهتها الشرقية: ثلاثة أبواب متفرقة: أحدها: يعرف الآن بباب البرقية، والآخر: بالباب الجديد، والآخر: بالباب المحروق، ومن جهتها الغربية ثلاثة أبواب: باب القنطرة، وباب الفرج، وباب سعادة، وباب آخر يعرف: باب الخوخة.
باب زويلة
تقع هذه البوابة إلى الجنوب مِن حصن القاهرة الفاطمي، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة من البربر بشمال أفريقيا، انضم جنودها إلى جيش جوهر لفتح مصر. وباب زويلة هو الباب الثالث الذي لا يزال يقاوم عوامل الزمن والإهمال بعد بابي النصر والفتوح، ويعتبر هذا الباب أجمل الأبواب الثلاثة وأروعها، وله برجان مقوسان عند القاعدة، وهما أشبه ببرجي باب الفتوح، ولكنهما أكثر استدارة.
وتطل بوابة باب زويلة حاليًّا على شارعٍ تحت الرَّبْع، ويَذْكر المقريزي والقلقشندي أنَّ البوابة القديمة التي أنشأها جوهر الصقلي كانت قائمةً حتى عصرهما، بالقرب من مسجد سام بن نوح، وأن البوابة الأولى كانت بفتحتين متجاورتين، فلما جاء المعِزُّ لدين الله إلى القاهرة بعد أن أسَّسها جوهر، دَخل مِن الفتحة اليُمنى، فتَفاءل الناس بها، وتُرِكت اليسرى لخروج الجنازات.
ويشغل باب زويلة مساحة مربعة، طول كل ضلع من أضلاعها (25 مترا)، وممر باب زويلة مسقوف كله بقبة، وقد اختفت منه معظم العناصر الزخرفية. وعندما بنى الملك المؤيد أبو النصر شيخ مسجده عام 818هـ، اختار مهندس الجامع برجي باب زويلة وأقام عليهما مئذنتي الجامع. ويذكر المؤرخ الشهير (القلقشندي) الكثير عن باب زويلة، ويورد كل من المقريزي والقلقشندي أبياتا من الشعر كتبها على بن محمد النيلي تتحدث عن عظمة هذا الباب، ومنها قوله:
يــا صاح لو أبصرت بــاب زويلة *** لعلمــت قــدر محلــه بنيانــا
بـاب تـأزر بالمجــرة وارتــدى ال *** شعــرى ولاث برأسـه كيوانا
لــو أن فــرعـونــا رآه لــم يـــرد *** صرحــا ولا أوصى به هامانا
ويطلق العامة على باب زويلة بوابة المتولي، حيث كان يجلس في مدخله (متولي) تحصيل ضريبة الدخول إلى القاهرة! وهذه البوابة لها شهرتها في التاريخ المملوكي والعثماني؛ حيث شُنِق عليها الكثيرُ مِن الأمراء وكبار رجال الدولة، ولم يتوقَّف استخدامُها لتعليق رؤوس المشنوقين عليها إلا في عصر الخديوي إسماعيل [3].
سور بدر الجمالي وأبوابه
وقد أنشأ أمير الجيوش بدر الجمالي سورا مِن الحجر، بعد أن تهدَّم سور جوهر الصقلي، وجاء بناء هذا السور بعد أن وسَّع مساحة القاهرة بمقدار 150 مترًا إلى شمال السور القديم، وحوالي ثلاثين مترًا إلى الشرق وإلى الجنوب، وأقام بدر الجمالي أسوارَه وبواباتِها خلف أسوار وأبواب جوهر الصقلي وموازيةً لها، وتم البناء من الحجر المنحوت، مصقول السطح، المثبَّت في صفوف منتظمة، وما زال هذا السور بأبوابه قائمًا حتى اليوم يشهد بعظمة العمارة الإسلامية في القاهرة الفاطمية.
سور قلعة صلاح الدين
شُيِّد هذا السور في أيام الناصر صلاح الدين الأيوبي، الذي حرص على تحصين القاهرة، فبَنَى قلعة صلاح الدين، وأمر بهاء الدين قراقوش ببناء أسوار القاهرة، وذلك عام 566 هـ، ويقال: إنه سخَّر أعدادًا كثيرةً مِن أَسْرى الفِرَنْجة في بناء القلعة والأسوار، وقد أقام قراقوش سورًا دائريًّا على القاهرة وقلعة الجبل والفسطاط، وجعل فيه عدة أبواب، منها: باب البحر، وباب الشعرية، والباب المحروق.
وقد كَشفت حفائرُ الفسطاط -التي بدأت عام 1912م وانتهت عام 1920م- عن القسم الشرقي القائم من سور صلاح الدين بين القلعة وحدود الفسطاط من الجهة الجنوبية.
باب النصر
يعتبر باب النصر أحد أقدم بوابات القاهرة. ولقد تم بناؤه عام 1087م وعمل كأحد البوابات الشمالية الشرقية للقاهرة الفاطمية. وعلى العكس من الأبراج الأسطوانية التي يتميز بها كل من باب زويلة وباب الفتوح، فإن برجي باب النصر لهما شكل مستطيل ويمكنك رؤية بعض الآثار البيزنطية في طرازهما المعماري. ولقد استخدم في البناء الكثير من الأحجار التي أًخذت من الآثار الفرعونية وإذا نظرت بالجوار فقد ترى بعض النقوش الهيروغليفية.
مما يُؤْسَف له أنَّ هذه البوابةَ وغيرَها استُخدمت في عهد الحملة الفرنسية، وأَجرى قَوَّادُ الحملة عليها بعضَ التعديلات المعمارية، خاصة في الغرف العلوية؛ بتحويل فتحات المزاغل الضيقة إلى فتحات للبنادق أو لفوهات المدافع.
باب الفتوح
تقع هذه البوابة بالجهة الشمالية الغربية من السور الشمالي الذي جدده بدر الجمالي سنة 480هـ، ويُذكر المقريزي أن البوابة القديمة التي أنشأها جوهر كانت قائمةً حتى عهده، وأنه تخلَّف منها بقايا أَقْبِيَةٍ ودِعَامات، وبعض الكتابات الكوفية، وإنها كانت على رأس حارة بهاء الدين إلى الجنوب من جامع الحاكم، ومن المعروف أن هذا الجامع بُنِيَ خارج أسوار جوهر الصقلي؛ لأن القاهرة وقت بنائه لم يكن بها مساحات كافية تستوعب جامعًا ضخمًا كهذا الذي أعده صاحبه ليكون دارًا للحكمة، وحينما جدد بدر الجمالي أسوار القاهرة أدخل فيها الجامع الحاكمي.
وتعَدُّ بوابة الفتوح آيةً في الجمال الزخرفي؛ حيث حليَتِ الأبراج من أسفلها بثلاث حشوات معقودة، واحدة بالواجهة واثنتان جانبيتان، وهذه الحشوات مكونة من صنجات متتالية تشبه الوسائد، وتفضي بوابة الفتوح إلى دركاة مربعة، على جانبيها دخلات لجنود الحراسة، ويسقف الدركاة قبة ضحلة مقامة على مثلثات كروية من الحجر [4].
أبواب القاهرة في العصر الأيوبي
وقد أُنشِئَت في عصر الدولة الأيوبية مجموعةُ أبواب، مرتبطة بسور القاهرة الذي بناه صلاح الدين، ومنها:
أ- باب الشعرية: يعرف بطائفة من البربر يقال لهم: بنو الشعرية، هم ومزانة وزيارة وهوارة من أحلاف لواتة الذين نزلوا بالمنوفية. أزيل سنة 1884م؛ لِخَلل في بنائه.
ب- الباب الأحمر في القلعة: يعرف ببرج المقطم، ويُشْرِف على باب المقطَّم.
جـ- باب البحر: أنشأه صلاح الدين في السور الشرقي المشْرِف على الصحراء، ولا تزال آثاره باقيةً حتى اليوم.
د- باب الوزير: يقع بين الباب المحروق وقلعة الجبل، وما زال موجودًا حتى الآن.
هـ- الباب المدرج: أقدم أبواب قلعة الجبل، أنشأه صلاح الدين سنة 579هـ، ولا يزال موجودًا على يسار الداخل إلى القلعة.
و- باب السلسلة: يطل على ميدان صلاح الدين في القلعة، ويعرف بباب العزب.
ز- باب السر: خصص لأكابر الأمراء وخواص الدولة، ويعرف الآن باسم الباب الوسطاني.
ولا شك أن الآثار المتبقية من هذه الأبواب القديمة حتى اليوم، تدل على روعة تصميم وشموخ العمارة الإسلامية [5].
[1] راغب السرجاني: الدولة العبيدية الفاطمية في مصر، مقال على موقع قصة الإسلام.
- مجدي إبراهيم علي: أسوار القاهرة وأبوابها، شبكة الألوكة.
[2] المقريزي: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، تحقيق: جمال الدين الشيال، الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، الطبعة: الأولى، 1/ 112.
[3] المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1418هـ، 2/ 239- 241.
- محمد رفعت: باب زويلة الأكثر شهرة بين أبواب القاهرة التاريخية، موقع الحضارة.
[4] الهيئة المصرية للسياحة.
[5] مجدي إبراهيم علي: أسوار القاهرة وأبوابها، شبكة الألوكة.








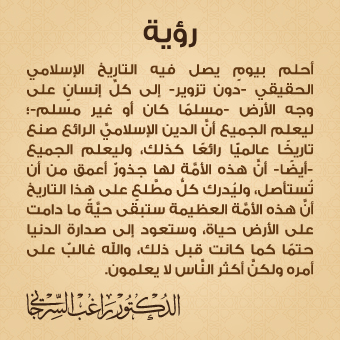


التعليقات
إرسال تعليقك