يعرض المقال بعضا من أخلاق العرب قبل الإسلام، والتي تبين التدهور الأخلاقي في المجتمع العربي، كشرب الخمر ووأد البنات والأنكحة الفاسدة
العلمانية والعالم الإسلامي
أتاتورك والعلمانية في تركيا
ظلَّت الأفكار العلمانية تتسلَّل إلى عالمنا الإسلامي، وتتوغَّل يومًا بعد يوم مستغلَّة حالة الضعف التي سادت بلاد العالم الإسلامي مع تهاوي دولة الخلافة العثمانية، التي كانت بمنزلة السدِّ الأخير الذي يحمي البلاد الإسلامية من الغرب الاستعماري وأفكاره المسمومة..إلى أن جاء يوم 27 رجب 1342هـ الموافق 3 مارس 1924م، الذي قام فيه الرئيس التركي "العلماني" مصطفى كمال أتاتورك بإلغاء الخلافة الإسلامية، وإعلان فصل الدين عن الدولة، وإلغاء المحاكم الشرعية، ووزارة الأوقاف، بل وأكثر من ذلك؛ فقد طرد الخليفة عبد المجيد الثاني آخر خليفة عثماني وأفراد عائلته من البلاد(5).
ثم توالت بعد ذلك الإجراءات الانقلابية -التي في عُرف العلمانيين تُسَمَّى إجراءات تحديثية وإصلاحية- فأصدر أتاتورك العديد من التشريعات الجائرة؛ بهدف فَصْم أي علاقة بين تركيا وجذورها الإسلامية، فقام بإلغاء كتابة اللغة التركية بالحروف العربية، وأمر بترجمة القرآن إلى اللغة التركية، وجعل الأذان للصلاة باللغة التركية، واستبعد قدر استطاعته أي كلمة عربية من اللغة التركية، كما اتخذ التقويم الغربي تقويمًا رسميًّا للدولة بديلاً عن التقويم الإسلامي، وجعل العطلة الأسبوعية الأحد بدلاً من الجمعة، ثمَّ أصدر قانونًا جديدًا سمَّاه القانون المدني؛ ليُعيد هيكلة المجتمع التركي اجتماعيًّا واقتصاديًّا -حتى أحواله الشخصية- على أُسس غربية بعيدة عمَّا أَلِفه الأتراك وتربَّوْا عليه لمئات السنين(6).
لقد فعل أتاتورك "العلماني" بدولة الخلافة ما لم تتوقَّعه أكثر الدول الاستعمارية بغضًا وكراهية للدولة العثمانية؛ فمَنْ ذا الذي كان يتخيَّل -إضافة لما ذكرنا- أن تُغْلَق المساجد في قلب دولة الخلافة، ولا يُسمح على أراضيها ببناء أكثر من مسجد واحد في كل دائرة من الأرض يبلغ محيطها 500 متر مربع، ويُعْلَن صراحة فيها أن الروح الإسلامية تعوق التقدُّم!
ولم يكتفِ أتاتورك بذلك، بل تمادى في تهجُّمِهِ على المساجد فخَفَّض عدد الواعظين، وأغلق أشهر مسجدَيْن في إسطنبول؛ فحوَّل أوَّلهما وهو مسجد آيا صوفيا إلى مُتحف، وحوَّل ثانيهما وهو مسجد الفاتح إلى مستودع(7).
وجهر أتاتورك -بعدما تمكَّن من الحكم- بنظرته المفتونة بالغرب؛ فولَّى وجهه شطر أوربا على أنها النموذج مضمونًا وشكلاً، فكان بذلك أول زعيم مسلم يتبنَّى الحضارة الأوربية نهجًا رسميًّا للدولة، ومن أقواله: "الحضارة التي يجب أن يُنشئها الجيل التركي الجديد هي حضارة أوربا مضمونًا وشكلاً؛ لأن هناك حضارة واحدة حقيقية وهي الحضارة الأوربية القائدة، والحضارة الموصِّلَة إلى القوَّة والسيطرة على الطبيعة، وخَلْقِ الإنسان السيِّد والأمة السيدة... وإن جميع أمم العالم مضطرَّة إلى الأخذ بالحضارة الأوربية؛ لكي تُؤَمِّن لنفسها الحياة والاعتبار"(8).
وعند زواجه من لطيفة هانم ابنة أحد أغنياء أزمير -الذين كانوا على صلة كبيرة مع اليهود من سكان أزمير- أجرى مراسم الزواج على الطريقة الغربية؛ ليُشجِّع على نبذ العادات الإسلامية، ثم قام باصطحاب زوجته وطاف بها أرجاء البلاد؛ وهي بادية المفاتن تختلط مع الرجال، وترتدي أحدث الأزياء؛ وذلك في تحريض فجٍّ على التبرُّج الصارخ، لتكتمل المنظومة التي أسَّس لها أتاتورك بإلغائه للحجاب الإسلامي، ودعوته إلى السفور، وإنهائه لقوامة الرجل على المرأة؛ بحجَّة إعطائها كامل حريتها، مع تشجيعها على حضور الحفلات الراقصة المختلطة(9)!
بالطبع كانت لخطوات مصطفى كمال أتاتورك تداعيات بعيدة الأثر في مصر وأفغانستان، وإيران، والهند الإسلامية، وتركستان، بل وفي كل مكان من العالم الإسلامي؛ إذ أتاحت الفرصة لدعاة التغريب وخُدَّام الثقافة الاستعمارية أن ينفذوا إلى مكان الصدارة، وأن يضربوا المثل بتركيا في مجال التقدُّم والنهضة المزعومة، فقد هلَّلت له صحف مصر -الأهرام والسياسة والمقطم- ذات الاتجاهات المضادَّة للإسلام، والمدعومة بقوَّة في ذلك الوقت بالمال الغربي والصهيوني والماسوني(10)، والتي برَّرت تصرُّفات أتاتورك ووافقت على ما ابتدعه، ونشرت له أقوال: "ليس لتركيا الجديدة علاقة بالدين"، و"إن ارتقاء الشعوب لا يصلح أن يُنَفَّذ بقوانين وقواعد سُنَّت في العصور الغابرة (يقصد أحكام القرآن)"(11).
وفي 3 فبراير عام 1937م أُقِرَّت العلمانية كعقيدة سياسية للدولة التركية، وعُدِّلت المادة الثانية من الدستور التركي لتُصبح: "دولة تركيا جمهورية قومية شعبية علمانية، وثورية مركزية". لتكتمل أُسس البناء الذي خطَّط له أتاتورك، وبدأه بتعديل موادِّ الدستور، التي أغفلت النصَّ بأن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وحذفت الموادَّ التي تُحتِّم قَسَم رئيس الجمهورية ونوَّاب الشعب "بالله" عند أدائهم لليمين الدستوري، واستبدالها بالقسم "بالشرف"(12)!
ثم تُوُفِّيَ أتاتورك في عام 1938م بعد إقراره للعلمانية كعقيدة سياسية بعام واحد، فمات في سنِّ الثانية والخمسين في مدينة إسطنبول، بعد معاناة مع العديد من الأمراض منها تليُّف الكبد الناتج عن إدمانه للخمر(13).
العلمانية والعالم الإسلامي
بورقيبة والعلمانية في تونس
كان أتاتورك أول حاكم لدولة مسلمة يتبنَّى الفكر العلماني، ولكنه لم يكن الأخير؛ فقد انتشرت العدوى الخبيثة في أغلب دول العالم الإسلامي، وبذريعة تبدو في ظاهرها أمينة ومخلصة، وهي ذريعة تقليد الغرب في تقدُّمه العلمي والتكنولوجي، فمرَّت السنوات والعقود ولم نَرَ تقدُّمًا ولا علمًا!! بل استوردنا من الغرب أسوأ ما فيه من مباذل أخلاقية وانحلال وتفكك أسري ومجتمعي.والأمر لم يتوقَّف عند أتاتورك فقط، بل رأينا التجربة السلبية نفسها تتكرَّر، وبشكل أكثر فجورًا في تونس الشقيقة على يد زعيمها الحبيب بورقيبة؛ فبعد معاناة الشعب التونسي على مدار سنوات طويلة تجرَّع فيها القهر والذلَّ والمهانة على يد قوَّات الاحتلال الفرنسي -جيش الدولة التي تُعَدُّ قلعة العلمانية وتتشدَّق باحترامها للحرية وحقوق الإنسان- بدءًا من قمعها الدموي لأي بادرة مقاومة تونسية تُريد الاستقلال وتنادي بحقِّها "الإنساني" في الحرية والكرامة، ومرورًا بسرقة الاحتلال لثروات الدولة ومواردها الاقتصادية عيانًا بيانًا وعلى رءوس الأشهاد، إضافةً إلى جهود "الفرنسة" الحثيثة التي اعتمدها الاحتلال؛ بهدف تذويب المجتمع التونسي ومحو هويته، ولعلَّ أبرز هذه الجهود هو ما رأيناه من إعلان الاحتلال للحرب على اللغة العربية -لغة القرآن- وهي أكثر ما يربط أبناء الشعب التونسي بأصوله وجذوره الإسلامية العريقة.
وأخيرًا وبعدما انكشفت الغمَّة وذهب الاحتلال، وحصل التونسيون على حريتهم واستقلالهم.. ليبدَءُوا عهدًا جديدًا تحت قيادة تونسية "وطنية"، تعهَّدت أن تمحو آثار الذلِّ والهوان، وتأخذ بيد البلاد إلى النهضة والتقدُّم، قرَّر المجلس التأسيسي التونسي في 25 يوليو 1957م إعلان الجمهورية، وتمَّ اختيار الحبيب بورقيبة كأول رئيس لجمهورية تونس..
باستعراض صفحات التاريخ نجد أن تونس دولة مسلمة رائدة، كان لها السبق في الإسلام في شمال إفريقيا، وكانت قاعدة مهمَّة لانطلاق الجيوش والدعاة والعلماء إلى أقطار إفريقيا المختلفة، ومنذ الاحتلال الفرنسي لتونس عمل الاحتلال وأتباعه على تحويل هذا البلد إلى مركز للعلمانية؛ وللطريق إلى ذلك اتخذت قيادات تونس خطوات واسعة نحو علمانية شاملة في جميع الجوانب التعليمية؛ حيث بدأت بتغيير مناهج التربية الإسلامية في القطاعات التعليمية كافَّة، وصولاً إلى جامعة الزيتونة، ووضعوا جُلَّ تركيزهم على تغيير مادَّة التربية الإسلامية من عدَّة جوانب؛ فبدءوا في التشكيك في كل شيء، بما في ذلك المعلوم من الدين بالضرورة؛ مثل: الأنبياء، والعصمة، والملائكة، والقرآن، والسُّنَّة، ونحوها من المسائل الغيبية!
كما تمَّ استبعاد الموضوعات الشرعية والفكرية الإسلامية، التي لها علاقة بالفكر السياسي الإسلامي؛ مثل الحكم والخلافة، وركَّزت المناهج الجديدة على إظهار التاريخ الإسلامي السياسي بمظهر الصراع اللانهائي على السلطة، والقتل والخداع والمحاربة من أجل "الكرسي" والحفاظ على العرش، حتى ولو سُخِّر الدين ووُظِّفت آلياته في سبيل ذلك!
بدأ بورقيبة منذ أيام حكمه الأولى يُظهر وجهه الحقيقي بغرامه لفرنسا، وعشقه لباريس، وافتتانه بالحضارة والثقافة الغربية، وانبهاره بمبادئ الثورة الفرنسية، وبشخصية شارل ديجول، كما لم يُخْفِ ولعه بمصطفى كمال أتاتورك الأب الروحي للعلمانيين الأتراك والعرب، بل كان يعتبره مثله الأعلى وقدوته في الحياة.
وكانت صورة أتاتورك رغم هلاكه مطبوعة في مخيلة بورقيبة؛ فكرَّس جهوده، وبذل وسعه واستخدم جميع مواهبه وإمكانياته العقلية والنفسية، كما استفاد من قدراته الخطابية وذكائه وشخصيته القوية في تطبيق المشروع العلماني في تونس، وكذلك في محو هويتها العربية والإسلامية؛ فطارد العلماء والدعاة، وألغى جميع الأحزاب، وقصف جميع الأقلام، وعصف بكل المعارضين.
لم ينتظر بورقيبة كثيرًا ليبدأ مخطَّطَه، بل استثمر حالة الحماس والالتفاف الشعبي حوله في فترة ما بعد التحرُّر، وأصدر بعد ثلاثة أشهر فقط من الاستقلال مجلة تحت اسم "مجلة الأحوال الشخصية"، وفي هذه المجلة بدأ يُصدر التشريعات التي تُعيد تشكيل المجتمع التونسي وَفق الرؤية الفرنسية "العلمانية"، وهكذا بدأت تتوالى التشريعات المخالفة للإسلام منذ الأيام الأولى لحكم بورقيبة.
ولقد حطَّ بورقيبة من قَدْر رموز التاريخ التونسي، وشوَّه صورتهم وبطش بأبناء الحركة الإسلامية، وشرَّدهم وأذاقهم الويلات، وسامهم سوء العذاب.
كما نزل بورقيبة إلى الشارع بعد الاستقلال ونزع بيديه الحجاب عن المرأة التونسية!! ثم سنَّ قانونًا يمنع ارتداء الحجاب ويعتبره زيًّا طائفيًّا يُشَجِّع على الانقسام داخل المجتمع.
وعمل بورقيبة بكل جهده في توفير جميع السبل وتسهيل كل الطرق المؤدِّية إلى اختلاط الشباب بالفتيات، ففتح المواخير وأمدَّ البارات بالمعونات، ووضع أجهزة إعلامه تحت تصرُّف العلمانيين.
لقد أحاط بورقيبة نفسه بحاشية من اللصوص والمفسدين، فطارد المصاحف، وراقب المصلِّين، وجفَّف منابع التدين، وبدَّل المناهج، وثار على الأعراف، وحارب التقاليد.
باختصارٍ أعلن بورقيبة الحرب على الإسلام وأخلاقه وقيمه ومبادئه ومظاهره، ونذر نفسه لمحو هوية تونس الإسلامية، وحاول الاستقلال بتونس وشعبها المسلم لا عن فرنسا واحتلالها وتبعيتها، بل عن الإسلام وتاريخه وحضارته وثقافته.
ثم تجاوز بورقيبة ما كان يفعله أتاتورك؛ فقد أعلن نفسه ندًّا لرب العالمين، بعدما صرَّح أن القرآن مليء بالمتناقضات، وبعدما سخر واستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فراح يُبَدِّل أحكام الله عز وجل، ويسنُّ قوانين أخرى "أكثر تطورًا وعصرية وتناسبًا مع المجتمع وحاجاته" كما يدَّعِي.
فأصدر قانونًا يُبيح التبنِّي، وقانونًا يمنع الزوج من طلاق زوجته إلاَّ بإذن من القضاء، وسمح بورقيبة للمرأة بالإجهاض، بل سمح للزوجة أن تُجهض نفسها دون إذن زوجها!
كما دعا بورقيبة عام 1956م إلى منع الصوم على الشعب التونسي، حتى في شهر رمضان؛ بدعوى أن الصوم يُقَلِّل الإنتاج ويعوق تقدُّم تونس ونهضته(14)!
إلى جانب ما عانته المرأة التونسية من محاولات مستميتة للقضاء على الحجاب؛ فبسبب الصحوة الإسلامية -التي حدثت في السبعينيات- أصدر بورقيبة قانونًا في سنة 1981م وصف فيه الحجاب بالزي الطائفي، ووزَّعت الجهاتُ الرسمية على أئمة المساجد منشورًا تحثُّهم فيه على تشجيع خلع المرأة حجابها، وأنه ليس من الدين في شيء.
ونشطت الشرطة في مطاردة المحجَّبَات في الشوارع، ومُنعت المحجبات من الأعمال الحكومية، وتعرَّض الأزواج والآباء للمساءلة في حالة وجود محجبة في بيوتهم، بل إن المحجبة كانت لا تستطيع أن تلد في مستشفيات الحكومة!
وقد تمَّ اعتقال مئات النساء والفتيات المتديِّنات، وتعذيبهن ومحاكمتهن، وإيداعهن السجون من غير جريرة غير ارتداء اللباس الإسلامي وأداء الصلاة، وهذا ما أفضى إلى إصابة العشرات منهن بانهيار عصبي بشهادة المنظمات الإنسانية(15).
ذلك إضافة إلى فرض العديد من القوانين الحمقاء، التي لا تُعطي أدنى اعتبار للأحكام الشرعية؛ مثل: منع تعدُّد الزوجات, وإباحة الزنا، وذلك بالتوازي مع حظر الدروس والحلقات القرآنية في المساجد، واعتبار مجرَّد مواظبة الشباب على الصلاة في المساجد دليل تطرُّف يُوجب الملاحقة!
ثم تعميم نوادي الرقص المختلط في جميع المدن والقرى التونسية والأرياف والأحياء, وترغيب الشباب من الجنسين على الانخراط فيها, وترهيب أوليائهم من مغبَّة التصدِّي لهم، والعمل على إشاعة السحر والشعوذة والكهانة بفتح مكاتب للكهان والسحرة، ونشر إعلاناتهم في الصحف والدوريات(16)!
زين العابدين يسير على خُطا بورقيبة !
وبعد بورقيبة تسلَّم زين العابدين بن علي الحكم في تونس من عام 1987م إلى أن فرَّ هاربًا من شعبه الذي ثار عليه في يناير 2011م؛ حيث كان حكمه امتدادًا لسابقه فلم يَكُفّ عن إطلاق الشعارات الرنانة عن الحرية والتقدُّم في ظلِّ "العلمانية"، بينما على أرض الواقع لم يعرف الشعب التونسي سوى الفقر والتخلُّف.فقد ركَّز زين العابدين "العلماني" جهوده -إلى جانب نهب ثروات البلد وكنزها لحسابه وحاشيته- في محاربة كل ما هو إسلامي!
خطة تمكين العلمانية في العالم الإسلامي
وإنه من دواعي الأسف أننا إذا أردنا التجوُّل والنظر في حال أغلب دول عالمنا العربي والإسلامي لوجدنا هذه النماذج نفسها؛ سواء أتاتورك أو بورقيبة أو زين العابدين -الذي لم يكن له نصيب من اسمه- فقد تكرَّر السيناريو الأليم نفسه في أغلب بلادنا؛ رئيس يخدع شعبه في بادئ الأمر بادِّعاء أنه "علماني" يُقَدِّس الحرية والعلم والمساواة، فإذا به "علماني" يُقَدِّس الفسق والفجور، ويعشق نهب الأموال وسرقة الأوطان. وبالطبع فإن هذا الجوَّ لا يستقيم معه أي صاحب دين أو أخلاق، فرأينا الحرب على الدين؛ لأنه يحضُّ على الطهر والاستقامة وطلب العلم، ورأينا تقريب الفاسدين والمنافقين وأصحاب المصالح.وكان يجب لتأمين خطَّة التمكين للعلمانية في عالمنا العربي والإسلامي -بجانب قوَّة وبطش السلطة- العمل على "علمنة" الإعلام؛ حيث أمسك دعاة العلمانية بزمام معظم وسائل الإعلام، وعاثوا فيها فسادًا؛ مثل: التلفاز والإذاعة والصحف والمجلات والسينما، وقد ظهرت أضرار تلك الوسائل في تحطيم الأخلاق والسلوك الطيب للجمهور، واسْتَمِعْ إلى ما قاله أعضاء المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة المنعقِد في المدينة المنورة سنة 1975م؛ فقد قالوا في مناشدتهم المسلمين جميعًا: "ويُنَدِّد المؤتمر بالهوَّة السحيقة التي تردَّى إليها إعلامنا، ولا يزال إلى اليوم يتردَّى، فبدلاً من أن يكون منبر دعوة إلى الحقِّ, ومنار إشعاع للخير، صار صوت إفساد وسَوْط عذاب، وخَفِتَ صوتُ الدعوة وَسْط ضجيج الإعلام الفاسد، وسكت القادة؛ فأقرُّوا بسكوتهم أو أجازوا ذلك فشجَّعُوا وحملوا, وزُلْزِلَ الناسُ في إيمانهم وقيمهم ومُثُلهم... ولم يَعُدِ الأمر يحمل السكوت عليه من الدعاة إلى الحقِّ"(17).
هذا إلى جانب ضجيج دعاة الحرية والفنِّ والانطلاق، وبعد أن كان الشرُّ منثورًا بين الناس أصبح مُنَظَّمًا, وله قوانين ودعايات وكُتَّاب ملئوا الدنيا ضجيجًا بواسطة هذه الأجهزة الإعلامية، التي أصبحت مصدرًا للخطر، وأيّما خطر على كل الفضائل؛ لأنَّهم أساءوا استعمالها, واستبدلوا فيها الذي هو أدنى بالذي هو خير، وشبَّت أجيال على هذا الانحراف، ولا يدري إلاَّ الله تعالى أين سيقف دعاة العلمانية بالبشرية(18).
وأصبح من المعتاد أن يخرج علينا كلَّ يوم ناعق جديد يُطلق على نفسه لقب "المفكر العلماني"؛ ليُخَرِّب عقول العامَّة ويهدم ثوابتهم الدينية والأخلاقية..
فهذا يُشَكِّكُ في صريح القرآن! وذلك لا يعترف بحُجِّيَّة الأحاديث النبوية! وثالث يسبُّ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويرميهم بأبشع التهم! وآخر يزعم أن الدين "بأكمله" لا يصلح لإدارة شئون حياتنا المعاصرة!
هل تجتمع العلمانية مع الدين ؟
ومن العجب أنك إذا وضَّحْتَ له وبَيَّنْتَ مغبَّة هذا الفكر "العلماني" وازدراءه للدين؛ يقول لك: أنا علماني، ولكني مسلم، وملتزم بأداء العبادات!وكيف تجتمع العلمانية مع الدين؟! وقد بَيَّنَّا أن أصل العلمانية هو تنحية الدين عن حياة الناس!!
إنك بذلك تُخالف أصول الفكر العلماني؛ فإمَّا أن تمتلك الجرأة وتصدع بإنكارك للدين وأحكامه، وإمَّا أن تجد لنفسك مصطلحًا آخر تُطلقه على الفكر الجديد الذي اخترته لنفسك، والذي تمزج فيه بين علمانية تكره كلَّ ما له صلة بالدين وبين التزامك بأحكام الشريعة الإسلامية، التي من أهمِّ أهدافها تعبيد الناس لربِّ العالمين، وحثِّهم على إعداد عُدَّتهم ليوم الحساب في الدار الآخرة ثم إلى جنة أو نار..
فإذا كنتَ تُؤمن بذلك؛ فما هذا الذي نراه ونسمعه ونقرؤه من المفكِّرِينَ العلمانيين "المسلمين" من استهزاء أو استخفاف بثوابتنا؟!
ثم نجد مَنْ يدعو للتقارب؟!
أيُّ تقاربٍ؟ وعلى أيِّ أساسٍ؟!
وماذا نفعل بعقيدة الناس التي تُطْعَن في كل يوم بخناجر المفكِّرين والإعلاميين وأصحاب الرأي "المسلمين"؟!!
عقيدة المسلمين هي المقصد الأول
الحفاظ على عقيدة المسلمين هو المقصد الأول للشريعة الإسلامية؛ لأنها الطريق الموصِّل لسعادتهم في الدنيا والآخرة، حتى وإن اضطر المسلم للتضحية في سبيلها بمتاع الحياة الدنيا الزائل..هل يفهم العلمانيون هذا المعنى؟
هل يفهمه العلماني الذي يتصدَّر المشهد ليعرض نفسه على الناس كمرشَّح لسُدَّة الحُكْم؟
هل يفهم أنه إذا ما تعارضت مصلحة دنيوية -مهما كان حجمها- مع عقيدة المسلمين، وجب عليه أن يُحافظ على عقيدتهم؛ ومن ثَمَّ يحفظ لهم آخرتهم التي هي معادهم؟
ألا يعلم العلماني -الذي يُريد أن يتصدَّر المشهد السياسي في الدول الإسلامية- أن مهمَّتَه الأولى هي حفظ دين المسلمين؟!
فإنك -مع الأسف- إذا عرضت هذه المفاهيم على أي علماني؛ فإنه ومن فوره سيتَّهِمُك بالجنون والعته!!
وإلى هؤلاء نُهدي موقفًا من التاريخ الإسلامي نراه غاية في الروعة، ولكننا على يقين أنهم سيرونه على عكس ذلك تمامًا!
فقد اتخذ سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قرارًا غاية في الخطورة بـ"عزل خالد بن الوليد" عن قيادة جيش المسلمين في الشام، في الوقت الذي كان فيه خالدٌ في قمَّة مجده وانتصاراته، لسبب واحد فقط رآه سيدنا عمر كافيًّا لاتخاذ مثل هذا القرار، ضاربًا عُرْض الحائط بما يُمكن أن يُقال عن المكاسب التي قد يخسرها المسلمون بهذا القرار.. فما هو السبب الذي دفع سيدنا عمر إلى اتخاذ هذا القرار؟
لقد عُزل خالد -رضي الله عنه- للحفاظ على عقيدة الناس، ولترسيخ مبدأ أن النصر من عند الله..
إن عُمَر عزل خالدًا بخشية افتتان الناس به؛ فإن خالدًا -رضي الله عنه- ما هُزم له جيش لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وقد جمع الله تعالى له بين الشجاعة والقوة والرأي والمكيدة في الحرب، وحُسن التخطيط والتدبير والعمل فيها، وقلَّ أن تجتمع هذه الصفات في شخص واحد.
ولذا كتب عمر -رضي الله عنه- إلى الأمصار: "إني لم أعزل خالدًا من سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فُتنوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع"(19).
والأعجب هو رد فعل سيدنا خالد بن الوليد -رضي الله عنه- الذي تقبَّل الأمر بصدر رحب، فقد ورد في مسند الإمام أحمد: عن عبد الملك بن عمير قال: استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح على الشام وعزل خالد بن الوليد. قال: فقال خالد بن الوليد: بُعث عليكم أمين هذه الأُمَّة؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدةَ بْنُ الجَرَّاحِ». قال أبو عبيدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ رضي الله عنه، وَنِعْمَ فَتَى الْعَشِيرَةِ»(20).
إضافة إلى تزكية خالد لعمر عند أبي الدرداء رضي الله عنه، وإخباره بأن عمر باب مغلق دون الفتن والمنكرات؛ فقد قال خالد لأبي الدرداء رضي الله عنهما: "والله يا أبا الدرداء! لئن مات عمر لترينَّ أمورًا تنكرها"(21).
كما نقل الحافظ ابن كثير أن خالدًا -رضي الله عنه- لما جُهِّزَ بكته البواكي، فقيل لعمر: "ألا تنهاهن؟ فقال: وما على نساء قريش أن يبكين أبا سليمان"(22).
فما رأي أصحاب الفكر والمنهج العلماني في هذا الموقف؟
ها هو رئيس الدولة لا يتأخَّر عن اتخاذ أي قرار فيه الحفاظ على عقيدة المسلمين؛ حتى وإن رأى فيه البعض التضحية ببعض المكاسب الآنية؛ وذلك في سبيل الحفاظ على مكاسب أخرى يُوقن بها المسلمون في الدار الآخرة.
المصدر: كتاب (قصة العلمانية).
(1) عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين: العلمانية وثمارها الخبيثة، موقع صيد الفوائد.
(2) انظر: علي بن نايف الشحود: موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة 12/275.
(3) السابق، الصفحة نفسها.
(4) صحيفة الوفد، 3 أكتوبر 2011م.
(5) وليد رضوان: تركيا بين العلمانية والإسلام، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت، لبنان، ط1: 2006م، ص45.
(6) محمود ثابت الشاذلي: المسألة الشرقية.. دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية، ص241.
(7) علي محمد الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، مؤسسة اقرأ، القاهرة، ط1: 2005م، ص443.
(8) محمد نور الدين: تركيا الجمهورية الحائرة، مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، ط1: 1998م، ص26.
(9) علي محمد الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، ص445.
(10) الماسونية: معناها الحرفي هي "البناءون"، وفي الإنجليزية Freemasons أي "البناءون الأحرار"، وهي منظمة يهودية سرية هدامة، إرهابية غامضة، محكمة التنظيم، تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد، وتتستر تحت شعارات خداعة "حرية - إخاء - مساواة - إنسانية"، وتُتَّهم الماسونية بأنها "من محاربي الفكر الديني" و"ناشرة للفكر العلماني". انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، 1/510.
(11) علي محمد الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، ص445.
(12) كمال حبيب: تركيا ومستقبل التدافع، التقرير الإستراتيجي الخامس لمجلة البيان، 1429هـ، ص224، 225.
(13) للاستزادة، انظر: قصة أردوجان، للمؤلف.
(14) عمر النمري: تونس الحديثة وصراع الهوية، مجلة البيان، بتاريخ ذو الحجة 1421هـ/ مارس 2001م، عدد 160، ص129-135.
(15) راجع تقرير منظمة العفو الدولية, الوثيقة رقم 93/2/30 بتاريخ 30 يونيو 1993م.
(16) انظر: الزمزمي: تونس الإسلام الجريح ص341- 344.
(17) غالب بن علي عواجي: المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات 2/750.
(18) غالب بن علي عواجي: المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات 2/752.
(19) الطبري: تاريخ الرسل والملوك، دار التراث - بيروت، ط2: 1387هـ، 4/68، وابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 1412هـ/ 1992م، 4/231، وابن الأثير: الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، ط1: 1417هـ/ 1997م، 2/360، وابن كثير: البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط1: 1408هـ/ 1988م، 7/93.
(20) مسند أحمد، طبعة مؤسسة قرطبة (16869)، وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. ومصنف ابن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد - الرياض، ط1: 1409هـ، (32264)، وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي - القاهرة، 1414هـ/ 1994م، 9/349.
(21) ابن عساكر: تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1415هـ/ 1995م، 16/271، والذهبي: سير أعلام النبلاء، دار الحديث- القاهرة، 1427هـ/ 2006م، 3/233.
(22) ابن عساكر: تاريخ دمشق 16/270، وابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 4/315، وابن كثير: البداية والنهاية 7/131، 132، وعَلَّقَ البخاري في صحيحه على "باب ما يكره من النياحة على الميت" قائلاً: "وقال عمر رضي الله عنه: دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ..". انظر صحيح البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، ط3: 1407هـ/ 1987م، 1/433.
أرادت أوربا الهروب من سجن الكنيسة ورجالها إلى نظام آخر يحترم العقل ويُحافظ على كرامة الإنسان، وبدلاً من البحث في الأديان الأخرى ساقتهم كراهيتهم لرجال الدين إلى الإلحاد الكامل، وإعلان الحرب على الدين، أيّ دينٍ بشكل عامٍّ؛ فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار!
وإذا كان هذا الذي حدث في بلاد الغرب النصراني ليس بغريب لجهلهم بأحكام الدين الصحيح، الذي ارتضاه الله عز وجل خالق الكون لعباده، فإنه غير ممكن في بلاد عرفت الإسلام، بل ولا متوقَّع حدوثه؛ فوحي الله في الإسلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحفظه الله عز وجل من التبديل والتحريف، ومن الزيادة والنقصان {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، وهو في الوقت نفسه لا يُحابي أحدًا؛ سواء كان حاكمًا أو محكومًا، فالكلُّ أمام شريعته سواء، وهو -أيضًا- يُحافظ على مصالح الناس الحقيقية، فليس فيه تشريع واحد يُعارض مصلحة البشرية، وهو -أيضًا- يحرص على العلم ويحضُّ عليه، وليس فيه نصٌّ شرعيٌّ صحيحٌ يُعارض حقيقة علمية..
فالإسلام حقٌّ كلُّه، خيرٌ كله، عدلٌ كله.. ومن هنا فإن كلَّ الأفكار والمناهج التي ظهرت في الغرب بعد التنكُّر للدين والنفور منه ما كان لها أن تظهر، بل ما كان لها أن تجد آذانًا تسمع في بلاد المسلمين، لولا عمليات الغزو الفكري المنظَّمة، والتي صادفت في الوقت نفسه قلوبًا من حقائق الإيمان خاوية، وعقولاً عن التفكير الصحيح عاطلة.
وسائل نقل العلمانية إلى بلاد المسلمين
لقد كان للنصارى العرب المقيمين في بلاد المسلمين دورٌ كبيرٌ في نقل الفكر العلماني إلى ديار المسلمين، والترويج له، والمساهمة في نشره عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، كما كان -أيضًا- للبعثات التعليمية -التي ذهب بموجبها طلاب مسلمون إلى بلاد الغرب لتلقِّي أنواع العلوم الحديثة- أثرٌ كبيرٌ في نقل الفكر العلماني ومظاهره إلى بلاد المسلمين؛ حيث افتُتِنَ الطلاب هناك بما رَأَوْا من مظاهر التقدُّم العلمي وآثاره..
فرجعوا إلى بلادهم محمَّلِينَ بكل ما رَأَوْا من عادات وتقاليد، ونُظم اجتماعية وسياسية واقتصادية، عاملين على نشرها والدعوة إليها، في الوقت نفسه الذي تلقَّاهم الناس فيه بالقبول الحسن، توهُّمًا منهم أن هؤلاء المبعوثين هم حملة العلم النافع، وأصحاب المعرفة الصحيحة، ولم تكن تلك العادات والنُّظم والتقاليد -التي تَشَبَّع بها هؤلاء المبعوثون وعظَّموا شأنها عند رجوعهم إلى بلادهم- إلاَّ عادات وتقاليد ونظم مجتمع رافض لكلِّ ما له علاقة أو صلة بالدين(1)!
وقد أدَّى نظام الابتعاث للخارج إلى ظهور قادة جدد أَثَّرُوا في مسار الأُمَّة وفي صناعة الأجيال، وهم كُثُر، ولنا في رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين ثم طه حسين وغيرهم أبلغ الأمثلة على تأثير نظام البعثات في المرجعية الإسلامية لعقول هؤلاء الرموز، وهذا مع احترامنا لكونهم هامات علمية كبيرة(2).
نُضيف إلى ذلك ما ساهمت به المدارس الأجنبية -التي انتشرت في البلاد الإسلامية- في إخراج أجيال من الشباب تربَّت على الفكر الغربي، ثم خرجت إلى المجتمع لتخترق جميع مؤسسات الدول من القمَّة إلى القاع(3).
ويكشف الدكتور محمد عمارة كيف ظهرت العلمانية في مصر بعد نجاحها في لبنان بواسطة مدارس الإرساليات النصرانية الفرنسية، التي ضربت عقولهم وصاغت وجدانهم وَفق المناهج التغريبية المعادية للإسلام؛ حيث كوَّنت هذه المدارس في لبنان جيشًا "ثقافيًّا" يعمل على خدمة علمانية فرنسا في الشرق، ثم هاجر كثير من جنرالات هذا الجيش إلى مصر؛ فأصدروا الصحف والمجلات، وأصبحوا بعبارة عبد الله النديم: "لا شرقيين ولا غربيين، اتخذتهم أوربا وسائل لتنفيذ آرائها، ووصولها إلى مقاصدها من الشرق".
كما أشار الدكتور محمد عمارة إلى شخصية من أخطر رجالات هذا الجيش العلماني، وهو "أمين شميل"، الذي يُعتبر أول مَنْ دعا إلى استخدام العامية العربية بدلاً من الفصحى لغة القرآن الكريم، فضلاً عن جنرال آخر هو "شبلي شميل"؛ الذي دعا إلى الدارونية الملحدة، مشيرًا إلى أن الدعوة إلى إحلال العلمانية الغربية وفصل الدين عن الدولة كانت واحدة من أخطر حملات التغريب..
ثم بدأ عدد من النصارى الموارنة من خلال مقالاتهم في جريدة المقطم -التي أنشأها الاستعمار الإنجليزي في مصر- بالدعوة إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة في الشرق الإسلامي، وقد واجههم الشيخ رشيد رضا، خاصة وأنهم كانوا يتخفَّوْن في نشر أفكارهم وراء ستار إسلامي؛ وذلك بدعوى أنهم مسلمون ويتهمون الإسلام بكراهية الآخر(4).









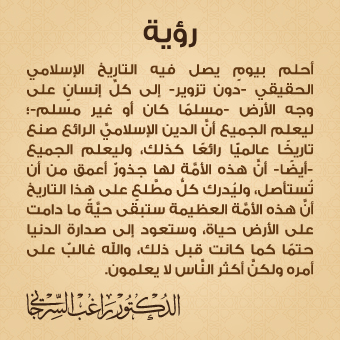


التعليقات
إرسال تعليقك