الحسبة في الإسلام مقال بقلم د. عبد الحليم عويس، يبين معنى وتعريف نظام الحسبة وتاريخ الحسبة في الإسلام ودور المحتسب، فما أهمية الحسبة؟ وما دور المحتسب؟
ملخص المقال
صور من التطبيقات الإسلامية لضريبة الجزية من التاريخ الإسلامي يقدمها الدكتور محمد عمارة، مبينا عدالة التطبيق فيها وعلاقتها بالجندية
لم تكن الجزية التي فرضتها الدولة الإسلامية على الذين دخلوا في دولتها ولم يدخلوا في دينها، اختراعًا إسلاميًا، وإنما كانت ضريبة معروفة فيما سبق الإسلام من دول وقوانين، فجاء الإسلام لينتقل بها من إطار التمييز الظالم إلى إطار العدل، الذي هو فريضة إسلامية، والروح السارية في حضارة الإسلام.
على من تفرض الجزية ؟
فالخراج على الأرض: ضريبة تتساوى فيها الرعية، المسلمون منهم وغير المسلمين.
وضريبة الجندية، وحماية الدولة، والدفاع عن رعيتها وأمتها كان المسلمون هم القائمون الأساسيون بأدائها، لاعتبارات أمنية اقتضتها المراحل الأولى من الفتوحات وتكوين الدولة، وحتى لا يجبر غير المسلمين على الانخراط في جيش يخوض معارك قد لا تقتنع بها ضمائرهم وثقافتهم التي لم تكن قد توحدت مع الثقافة الإسلامية في تلك المرحلة المبكرة من تكوين الدولة الإسلامية.
فكانت هذه الجزية بدلًا من الجندية، ولم تكن بدلًا من الإيمان بالإسلام، ويشهد على ذلك أنها لم تفرض إلا على القادرين على أداء الجندية، المالكين لما يدفعونه ضريبة لهذه الجندية، ولو كانت بدلًا من الإيمان بالإسلام توجبت على كل المخالفين في الدين.
ولم يكن أمرها كذلك، فهي لم تفرض على الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء ولا العجزة ولا المرضى من أهل الكتاب، وهؤلاء جميعًا مخالفون للمسلمين في الدين، كما أنها لم تفرض على الرهبان ورجال الدين، وهم من هم في مخالفة الدين! وكل الفقهاء -باستثناء فقهاء المالكية- يقولون: إنها "بدل عن النصرة والجهاد" [1].
تطبيقات إسلامية في الجزية
ولقد شهدت على ذلك أيضًا التطبيقات الإسلامية لضريبة الجزية:
1- لقد فرضت الجزية على القادرين - بدنيًا وماليًا - من نصارى نجران، وفي نظير ذلك كان إعفاؤهم من الجندية، فنصعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران على أنه "لا يُكلَّف أحدٌ من أهل الذمة منهم الخروج مع المسلمين إلى عدوهم، لملاقاة الحروب ومكاشفة الأقران، وأن يكون المسلمون ذُبَّابًا عنهم، وجوارًا من دونهم" [2].
2- وفي البلاد التي آثر فيها غير المسلمين أداء ضريبة الجندية مع المسلمين، لم تفرض عليهم الجزية، بل كانوا متساوين مع المسلمين في القتال وفي نصيبهم من غنائم هذا القتال، حدث ذلك في جرجان، ونصت معاهدة القائد سويد بن مقرون مع أهلها عليه، إذ جاء فيها: "ومن استعنا به منكم فله جزاؤه في معونته عوضًا من جزائه" [3]، وحدث ذلك مع أهل أذربيجان ونصت عليه معاهدة القائد عقبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع أهلها، إذ جاء فيها: ".. ومن حُشر (أي استدعي للقتال) منهم في سنة وُضع عنه جزاء (أي جزية) تلك السنة..." [4].
وحدث ذلك أيضًا مع أهل أرمينية ونصت عليه معاهدة القائد سراقة بن عمرو (30هـ/ 650م) عامل عمر بن الخطاب مع أهلها، إذ نصَّت المعاهدة على أن "يوضع (يسقط) الجزاء (الجزية) عمن أجاب إلى ذلك الحشر (الحشد للقتال)، والحشر عوض عن جزائهم (جزيتهم) ومن استغنى عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على أهل أذربيجان من الجزاء (الجزية)" [5].
وحدث ذلك أيضًا مع الجراجمة -سكان الجرجومة- في شمالي سوريا، بالقرب من أنطاكية، عندما حاربوا وهم على نصرانيتهم، ومعهم حلفاؤهم وأتباعهم، في جيش المسلمين، تحت قيادة حبيب بن مسلمة الفهري (2ق هـ - 42هـ/ 620 - 662م)، وحدث ذلك أيضًا مع النصارى من أهل حمص، عندما حاربوا في صفوف جيش أبي عبيدة بن الجراح (40ق هـ - 18هـ/ 584 - 644م) في موقعة اليرموك ضد الروم البيزنطيين [6]، وحدث ذلك أيضًا مع بني تغلب -وهم نصارى، أسقطها عنهم عمر بن الخطاب "لأنهم عرب يأنفون من الجزية" [7].
3- الجزية بديلًا عن الجندية: ومن أمثلة ذلك ما جاء في مفاوضات شهر براز ملك الباب مع القائد المسلم عبد الرحمن بن ربيعة (32هـ/ 652م)، عند عقد الصلح بينهما سنة 32هـ، فلقد قال شهر براز: "أنا اليوم منكم، ويدي مع أيديكم، وصفوي معكم وجزيتنا إليكم: النصر لكم والقيام بما تحبون.."، ولقد أجيب إلى طلبه، بعد مشاورة القائد عبد الرحمن بن ربيعة مع سراقة بن عمرو "30هـ/ 645م".
ولقد استمر ذلك سُنة متبعة في علاقات الدولة الإسلامية بشعوب البلاد المفتوحة، حتى ليقول الطبري عن إسقاط الجزية عن الذين انخرطوا في الجندية غير المسلمين: "وصار ذلك سُنة فيمن كان يحارب العدو من المشركين" [8].
[1] القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص411، طبعة دار الكتب المصرية، القاهرة.
[2] محمد حميد الله الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ص125.
[3] المصدر السابق، ص326.
[4] المصدر السابق، ص328.
[5] المصدر السابق، ص339، 340، وانظر كذلك تاريخ الطبري،ج4، 152، 155، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار المعارف، القاهرة، سنة 1970م.
[6] أبو يوسف: كتاب الخراج، ص138، 139، طبعة القاهرة سنة 1352هـ، وانظر كذلك: البلاذري فتوح البلدان، ص189، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، طبعة القاهرة، سنة 1956م.
[7] أبو عبيد القاسم بن سلام: كتاب الأموال، ص156، طبعة القاهرة، سنة 1968م، وأبو يوسف كتاب الخراج، ص120.
[8] تاريخ الطبري، ج 4، ص156.








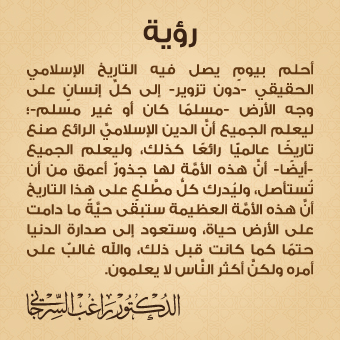


التعليقات
إرسال تعليقك